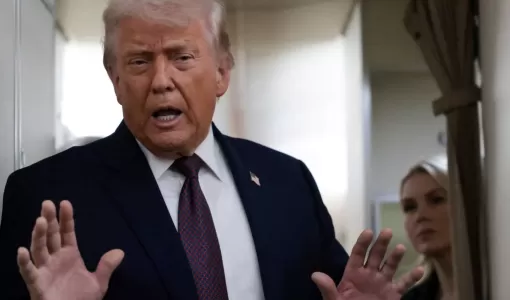حرب الكل ضد الكل.. هل أضرت الدولة بالمجتمع في قضية تصنيع الصواريخ؟
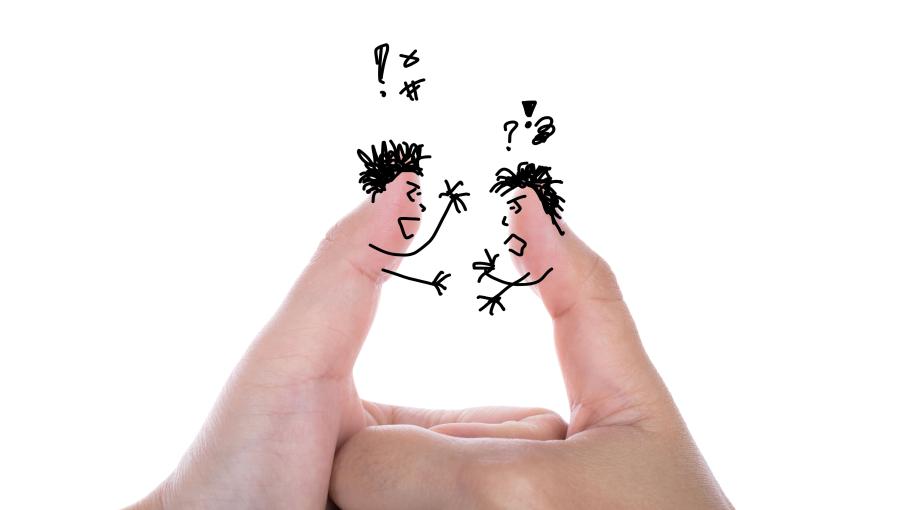
أصّل الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز في كتابيه "المواطن" وكتاب "اللفياثان: الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة" مصطلحا أو حالة تعيشها الجماعات تعرف بـ"حرب الكل ضد الكل". وربط بين هذه الحالة وفكرة العقد الاجتماعي والسلطة المطلقة.
خرج هوبز بهذه الأفكار في أثناء معايشته للحرب الأهلية في بريطانيا، وكتب أن الحرب الأهلية نتيجة طبيعية لحالة غياب القوة الواحدة المشتركة التي تبقي أفراد المجتمع الواحد متماسكا تحت قوة العقد الاجتماعي، إذ تخلق حالة غياب تلك القوة لدى الأفراد والجماعات شعورا فطريا إنسانيا بالخوف والتحسس فيدخل الجميع في مرحلة التنافس، والصراع، والعودة إلى غرائز البقاء وشريعة الغاب فتتنج "حرب الكل ضد الكل"، ولا يمكن تجنب هذه الحالة من منظور هوبز إلا عبر حكومة قوية غير منقسمة.
كيف تنعكس حرب الكل ضد الكل على المجتمع
وإن النتيجة هي أن يختار الناس الدخول في عقد اجتماعي، ويتخلوا عن بعض حرياتهم الفردية من أجل التمتع بالسلام والأمن المجتمعي. هذه التجربة الفكرية هي اختبار لشرعية الدولة في أداء دورها كـقوة "ذات سيادة" لضمان النظام الاجتماعي المتفق عليه.
ويميز هوبز بين الحرب والمعركة: فالحرب لا تتكون فقط من معركة عتاد وأسلحة في الميادين، بل تشير إلى الحالة التي يعرف فيها الأفراد أن هناك "إرادة للمنازعة وخوض المعركة" وهي مرتبطة بمحاولات استجرار التعاطف والتحشيد وتعزيز مراحل الاحتقان وخطاب الكراهية وغيرها من الممارسات التي تسبق التصادم والتي تؤول إلى حدوث المعركة الفعلية وتخلق البيئة المحفزة للتصادم والعراك.
ويشير هوبز في حالة "حرب الكل ضد الكل" إلى عدم وجود مكان للصناعة لأن ثمارها غير مؤكدة، ولا توجد ثقافة للأرض، ولا ملاحة ولا استخدام للسلع ولا بناء صالح، ولا نمو اقتصادي، ولا ازدهار سياسي، ولا أدوات للنقل، لا فنون، لا حساب للوقت، لا آداب، لا مجتمع.
والأسوأ من كل ذلك كله، الخوف المستمر من خطر الموت أو الإقصاء أو الإخفاء القسري، وتصبح حياة الإنسان في عزلة فردانية منعزلة فقيرة، وحشية وقصيرة يميل فيها الأفراد إلى التجمع ضمن فئات صغيره تؤمن القوة والكثرة أمام الآخر، فتنهار الثقافة، ونسيج المجتمع، والحضارة وتعود الإنسانية إلى العصور البدائية.
ابن خلدون يتفق مع هوبنز بضرورة وجود سلطة
ومن الجدير بالذكر، أن ابن خلدون في مقدمته الشهيرة، قد طرح مفهوما للحرب والصراع الاجتماعي، وقد اقترب من مفهوم توماس هوبز حول "حرب الكل ضد الكل"، فيرى ابن خلدون في "المقدمة" أن الحرب حالة طبيعية في حياة الأمم، وهي جزء من دورة العمران والبناء والدمار، ويؤكد على أن القوة والذكاء هما الأساس في الحروب، مع ضرورة تنظيمها وعدم الانجرار وراء الفوضى المطلقة، وهو ما يشبه تصور هوبز عن حالة غريزة البقاء التي يسودها الصراع والأنانية قبل تأسيس الدولة والعقد الاجتماعي.
ميز ابن خلدون بين أنواع الحروب، ولكنه اعتمد في التمييز على الغاية، فصنف الحروب بالغيرة والمنافسة والعدوان، وحروب الجهاد التي لها بعد ديني، ويبرر مشروعية الحرب في بعض الحالات، معتبرا أن الحرب تعكس صراع المصالح والسلطة بين الناس. كما يربط بين الحرب والعدوان والظلم في الطبيعة البشرية، ويؤكد على أهمية وجود وازع أو سلطة تمنع تفاقم الفوضى، وهو ما يشبه نتيجة هوبز بضرورة وجود سلطة قوية لكبح "حرب الكل ضد الكل" وهي سلطة العقد الاجتماعي.
إن التصيد في حالة الاقتراب من حالة "حرب الكل ضد الكل" لا يخلق قوة أو منعة وطنية تعزز سلطة العقد الاجتماعي، بل إن الخطابات التي تعزز حالة التصادم بين مكونات نسيج المجتمع الواحد، تتعدى على قوة العقد الاجتماعي، وتتجاوز مفهوم القوة المشتركة التي يحتمي بها كل من يخضع تحت سطوة الدولة الواحدة. فعندما تنصب فئة نفسها كحارس للوطنية أو العقد الاجتماعي بناء على معاداة الآخر، فهنا تلجأ الجماعات إلى غريزة البقاء بعد دفعها إلى حالة العزلة والخوف.
قضية تصنيع الصواريخ.. على الدولة أن تقف على مسافة واحدة من الجميع
الحالة الأمنية التي كشفتها أجهزة المخابرات الأردنية، ذات طابع أمني بحت، تمس أمن وسيادة العقد الاجتماعي الذي يسود الأردن. نثق في عدالة القضاء وقوته في كشف خفايا المؤامرات ومحاسبة كل متخاذل أو متآمر على سيادة العقد الاجتماعي كقوة مشتركة واحدة.
ولكن المتصيد ممن يريد أن يلبس الأمر الثوب السياسي، من باب خلق حالة الحرب الذي صنفها ابن خلدون بأنها مدفوعة بالغيرة والمنافسة والمناكفة، لن تعزز في وحدة النسيج، ولن تخلق إلا الانشقاق وتوليد البغضاء وشعور الفئات المكونة للنسيج الوطني بالخوف الذي يدفعها إلى الاقتراب من حالة "حرب الكل ضد الكل".
وعلى الدولة ذات السيادة القوية أن تحمي جميع أركان النسيج الوطني ومكوناته تحت سلطة العقد الاجتماعي، وأن تقف على مسافة واحدة من الجميع. وعلى كل متصيد أن يرجع إلى العقد الاجتماعي وينزل عن شجرة الظهور.
في نهاية المقال، اذكر برنامجا كرتونيا كان يبث على شاشة التلفزيون الأردني صباحا، تحت اسم زينعو ورينغو، وهي شخصيتان خياليتان ساذجتان، تحاولان إصلاحا ولكن في كل أفعالهما تجد الخراب والحماقة بسبب الاستهتار، وهذا ما نشاهده اليوم على شاشة أحد البرامج الحوارية عندما تتحدث شخصيتان تكرران حماقة كل منهما الآخر، في حالة من المناكفة والمراهقة الساذجة في إسقاط الحالة الأمنية على الحالة السياسية، هي حالة المناكفة البعيدة عن المصالح الوطنية العليا! ولن تتغير حماقة زينغو أو رينغو بتغير مواقعهما!
اقرأ المزيد.. ماذا نتعلم من قراءة شواهد الواقع.. بين شق النهر والطوفان!